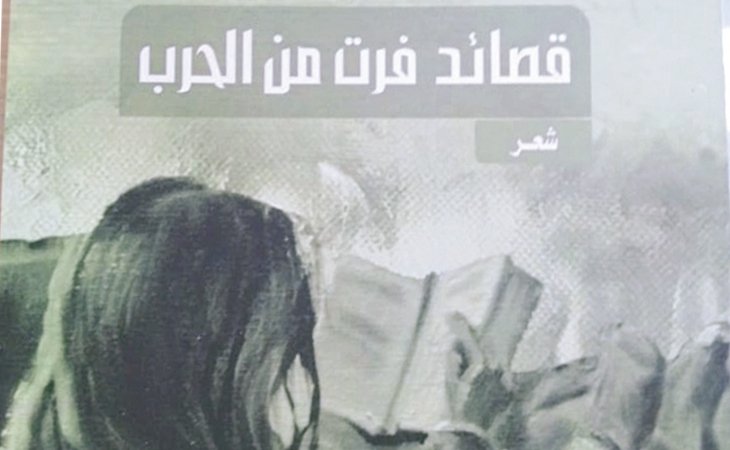أحمـد الصغير
—-
يسعى الشاعر حسونة فتحي في كتابه الشعري “قصائد فرت من الحرب” إلى طرح أسئلة مهمة في قصيدة النثر، حيث تبدو شعرية الحرب آلية من آليات الكتابة الشعرية، من خلال أسئلة مباشرة يمكن استنطاقها من رحم القصيدة ، ومن هذه الأسئلة: لماذا تفر القصيدة من الحرب؟ وهل يمكن للشاعر أن يفر بقصيدته من ويلاتها؟ أم ستظل الحرب بمعناها الحقيقي، والمجازي صورة ذهنية تتعلق بالخراب، والموت، والفناء، والعدم؟. أعتقدُ أن مفهوم الحرب في القصيدة النثرية لم يكن مفهوما مباشرا، كما الحال في الشعر العربي الحديث، فعنوان الديوان “قصائد فرت من الحرب” يحمل مشاهد متعددة للذات الشاعرة وعلاقتها بالحروب قديما وحديثا، حتى اللحظة الراهنة، وأعني تلك الحروب التي نعايشها كل لحظة في العالم المحيط بنا، وكأن هذه القصائد/ الكائنات فرت من حروب قديمة عايشتها الذات، فالحياة حرب، والحب حرب، والموت أحد منتوجات الحرب، فـ (دال) الحرب يحمل شحنات دلالية ثرية تكشف عن الألم الذي خلفته الحروب في جسد الشاعر وتصوراته الذهنية.
صحيح أن الأدب احتفى بالحروب راصدا ومسجلا لتفاصيلها، وويلاتها منذ الشعر الجاهلي، وحتى أدب الحرب في العصر الحديث، وغيرها من المصطلحات الأدبية التي تعتمد على قصص الحروب اعتمادا مباشرا في عملية الكتابة. ومن الملحوظ أن قصيدة النثر، تحتفي -عادة- بالتفاصيل اليومية البسيطة المتعلقة بالذات الشاعرة، هذه الذات المستعارة داخل القصيدة وخارجها، تبدو ككائن يتحرك جوانيا على الرغم من برانيته. فتتجلى صورة الحرب في ديوان الشاعر حسونة فتحي، (قصائد فرت من الحرب) -الهيئة العامة لقصور الثقافة / القاهرة، 2022. يضم مجموعة من النصوص الشعرية التي تقف مشرقة وواعية بصدرها العاري أمام حروب عدة في التاريخ المعاصر.
جاء ديوان ” قصائد فرت من الحرب” في ثلاثة كتب، كل كتاب يضم مجموعة من القصائد التي تصب في محور واحد، فجاء الكتاب الأول بعنوان (من كتاب السيرة) والثاني (ذاكرة آيلة للسقوط) والثالث (بلا أية مبررات). فمن الملاحظ أن الأجزاء الثلاثة في الديوان تمثل رحلة الشاعر في الحياة ، فالكتاب الأول يحمل صورة السيرة الذاتية للشاعر وعلاقته بالمكان، فتصبح الذاكرة مهددة بالسقوط التاريخي في ويلات الحرب، فتأتي أحداث الحياة بلا مبررات منطقية لأحداث الحروب، فتتمدد الذات الشاعرة في قصيدة حسونة فتحي، حيث تلجأ إلى قراءة العالم من خلال لغة شعرية تحتفي بالصمت وحضور الغياب، فيقول الشاعر:
“سنجلس الليلة صامتين،
أقرأ أفكارك من نظرة عينيك،
لعبنا هذه اللعبة كثيرا،
لكني أفشل دائما،
فأول ما أقرأ في عينيك “أحبك”
لأكسر الصمت، والقراءة بالقبلات،
ففي بلاد الحرب، لا تظهر العيون في الليل سوى حزن النهار،
وأنا تدربت كثيرا على قراءة الحزن في عين أمي”
تحكي القصيدة عن الصمت، والحزن، والحرب، فيكسر حاجز الصمت، والقراءة بالقبلات، حيث تطرح الذات صورة الحزن في عيون الحبيبة، وكأن هذه اللحظة لها رهبتها، فلا يناسبها سوى الصمت، والتأمل في الذات والآخر، وحقيقة التكوين، فيلجأ الشاعر إلى استخدام تقنيات مشهدية، متنوعة في القصيدة، فنلاحظ التداخل المشهدي بين قراءة العيون والحب وبين حالات الحزن التي خلفتها الحروب في بلاد تعيش في قلق واهتزاز إنساني مشوب بالألم، مما كان لها أثر دفين في النفس الإنسانية، فيستخدم الشاعر طريقة لصياغة الخبر من خلال قوله: “وأنا تدربت كثيرا على قراءة الحزن في عين أمي” فتبدو صورة الحزن في العين واضحة، وكأن الحزن نفسه يسكن في العيون، فتبكي العيون ولا تتكلم، حيث يسكن الحزن عيون الأمهات المكلومة، لكنها صامتة، فالصمت لغة الحزانى الخاشعين، ويقول أيضا في حديثه عن الذات:
“لن تصدقوني
إذا ما حدثتكم عن الرغبة
والشهوة، والشبق، والقدرة، والطاقة
فأنا رجل مسن،
تجاوزت الستين وفق السنوات الميلادية
وأكثر منها وفق التقويم الهجري”
يعتمد الشاعر على لغة شعرية متقشفة لا تحتفي بالزركشة اللفظية، بقدر اعتنائها بالبساطة والألم، لأنه يفر من المعنى المباشر إلى التحليق في ملكوت من المعاني اللانهائية. حيث تكون القصيدة -في ظني- ككتلة لهب تسير ببطء شديد، لتخترق الماضي من جهة وتحرق الحاضر من جهة أخرى. فهي لا تعتمد على الصخب والخطابة والجزع، فلا تخشى المجهول، بل تخترق كل حواجز الغيب. ولا تحتاج لفوضى التصفيق. بقدر احتياجها للإنصات والدفء والمعايشة البصرية للغة، فيبدأ في الحديث عن الذات بشكل مباشر، وهو اعتراف واضح للذات في قولها: (لن تصدقوني) وكأن الذات تترك ساحة الكذب لتدخل في الصدق المباشر، حيث تحدثنا القصيدة عن الشهوة، والقدرة والطاقة، والشبق، فكل مفردة من المفردات السابقة، تكتنز في حوصلتها المعجمية، والفنية داخل السياق الشعري عوالم الدلالات المختلفة، فهو الشبق النوعي والقدرة المعنوية على استمرار الحياة، وكأن الذات تفصل بين القدرة الحسية والقدرة الخيالية، بمعنى أنه على الرغم من تجاوزها الستين عاما، فإنها قادرة على التعبير عن شغفها بالحياة. كما يعتمد الشاعر على استعادة الصورة البصرية في الكتابة الشعرية فيقول:
“كحارس شخصي تقف الحرب على بابك.
تمنح نفسها حق الحجر التام عليك
أين تذهب؟ متى تعود؟
ماذا تقول؟ متى تصمت؟ وفيمَ تفكر ؟
وعليك الطاعة والامتثال .
الحرب كائن همجي، شره وشرس،
يغضب، فيحرق الأخضر واليابس
يرضى، فيتبعك إلى حجرة نومك،
وتحت ملابسك، وينهش جلدك وأحلامك”
اتكأ الشاعر في المقطع السابق على تفصيلات مشهدية بارزة، تبدأ بمشهد الحرب وتنتهي به حيث تكشف علامات القصيدة عن رؤى متعددة للشاعر حول الحرب ومدى الغطرسة الظلامية التي تشنها على الحياة بشكل عام، فيتجه الشاعر للرصد، والإجمال والتفصيل، فيصنع صورا بصرية للآلام التي تسببها الحروب في كل مكان، فالحرب تنهش الحياة وتبدد الحضارات وتقتل الأحلام في قلب كل طفل، فتقف الحروب على أبواب المدينة، تتحكم في حياة البشر، مقيدة حريتهم وتحركاتهم ومشاعرهم، تفرض نفسها من خلال أسئلة استبدادية، من خلال سياسة الحرب القمعية التي جاءت في صيغة أسئلة ( أين تذهب؟ متى تعود؟ ماذا تقول؟ متى تصمت؟ وفيم تفكر؟ فجل الأسئلة السابقة تحمل وجوه الحرب وأصحابها، متحكمة في تفاصيل حياة الناس، فتضيق الذات بكل هذه الأسئلة، وليس لديها سوى الطاعة والامتثال، فالحرب لها قوانينها التي لا تقبل التمرد أو النقاش، بل ليس لها سوى الطاعة والتنفيذ، فالحرب إما أن تكون صديقا أو عدوا، فهي لا تقف في منطقة وسطى، لكنها تكشف وتقتل وتمزق الشعوب، ويقول أيضا:
“أقفُ مفسحًا ما بين قدمي،
كوقفة جندي، ينصاع لأمر.
استرحْ: لست جنديا.
لكنني قادم من بلاد الحرب.
أقطع المسافة الطويلة بمشية الجنازة
فخلفي نار، ودماء، وجثث وكآبة تعتلي الوجوه
وأمامي ما لا حصر له من الكمائن”.
اتكأ الشاعر على مشهدية الصورة البصرية التي تخلخل الثوابت وتكسر التوقعات. وتنسف الصورة الذهنية عن رومانسية الذهاب إلى الحروب، فيستدعي عبر مشاهد مكتنزة صورة الجثث والكآبة والموت، والجنازات المرسومة بعناية على وجه الوطن، وتطرح قصائد الديوان الكثير من القضايا الكبرى والفلسفات وحياة الشعارات المتضخمة، ونلاحظ الحوار الشعري في القصيدة فيستخدم الشاعر الفعل (استرح) ليعلن من خلاله عن استراحة المحارب، فينصاع كجندي مغلوب على أمره، فيكشف الشاعر عن صورة الجثث والقتلى والكمائن المتعددة في طريقه إلى العريش، فالحرب ليست حربا خارجية بالأساس بل حرب داخل الذات وفي جغرافيا المكان الذي حاولت جماعة من الإرهابيين التمركز داخله، مما تسبب في وقوع الكثير من القتلى والشهداء، فيلجأ للحديث عن تفاصيل الروح فيقول:
“سأكتفي بما علمتك الطبيعة
لن أدعوك إلى قراءة كتاب ما
أو إلى حفل في الأوبرا
أو أحدثك بأفكار
جرت على لسان فيلسوف أو شاعر أو نبي
أو عن أحزان أي منهم
فقط، سأقص عليك بعض الحكايات،
عن رجل سكنت قلبه نساء كثيرات،
جميلات رغم الحزن، وطيبات رغم شراسة الحياة”
تتجلى في المقطع السابق صورة التخلي عن الأشياء الكبيرة والأحلام المهزومة، فقد تلجأ الذات إلى الحديث عن حكايات بسيطة عن العشق، وعن رجل يعشق النساء الجميلات رغم حزنهن، وطيبات رغم قسوة الحياة، فيلجأ الشاعر إلى التخلي عن القضايا الكبرى، في مقابل احتفائه بالحكايات العادية التي تمس الذات الشاعرة وعلاقتها بالتفاصيل البسيطة التي تسرد مشاهد المحبة والحب والجمال والحزن، وهي في ظني أكثر قدرة على البقاء والخلود والفناء في النسيج الإنساني الشفيف. ويقول الشاعر في قصيدة (الموت بلا وداع) مستدعيا فترة الحظر والموت أيام فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”:
“كواحد من الذين تجاوزوا الستين
والذين إذا أصابتهم مصيبة
تذكروا مصيبة تشبهها
أو تزيد عنها لعنة وقسوة
ومن الذين جاءتهم الحرب
من بين أيديهم ومن خلفهم
دون أن يغضبوا الله،
بقهر نسائهم، أو بترك عقولهم للجاهلين”
تطرح القصيدة صورة هؤلاء الرجال الذين تجاوزوا الستين وطحنتهم التجربة الحياتية ، والمصائب المتشابهة حيث وقعت الحرب عليهم دون أن تنبههم الطبيعة بما سيحدث لهم فهم قوم لم يعلنوا تمردهم على المجتمع بل كانوا وقودا لحرب ليس لهم فيها ناقة ولاجمل. بل أخذتهم في وجهها كما تأكل النار الأشياء دون تمييز. ونلاحظ التدفق الشعري للحدث بين حرب كورونا وحرب الإرهاب وبين التشاحن والتناقض وبين الحزن والحب والحرب.
ويقول في القصيدة نفسها :
“تقول الغريبة:
كل دمعة وراءها قريب،
ويقول طبيب:
تباعدوا كقطبين متنافرين
ولتكن مناعتكم قوية كبوابة قصر.
كيف؟ ولا مناعة مطلقا، في حضرة امرأة جميلة،
ولا عافية بلا أحضان الأحبة؟.
يسخر الشاعر في القصيدة الفائتة من تعليمات الأطباء حيث جاءت تحذيرات كثيرة، تتحدث إلى الناس بضرورة التباعد، وتقوية المناعة الداخلية والخارجية، فتتساءل الذات عن كيفية التباعد حيث لا مناعة في حضور امرأة جميلة، ولا عافية بلا أحضان. حيث تكسر الذات تلك التعليمات الخشنة، لتدخل في التمرد على الحياة، فالحياة دائما في الحب والأحضان والقوة، فيرصد الشاعر من خلال مرحلة كورونا صورة الحياة والعزلة الاجتماعية التي تعيشها الذات مجبرة على التعايش في ظل كورونا وأثرها على العلاقات الإنسانية المباشرة، ويقول في مقطع آخر:
“بكمامة محكمة على الفم والأنف
بقفازات تحد من حاسة اللمس
بمحاليل تطرد كائنات الفراغ
بمنظفات عدائية التكوين
بتوجس من عطسة بلغت مسامعك
برعب من سعال امرأة عجوز
يمضي نهار يومك
ولا شيء يحزن القلب
مثل فقد دون وداع”
يطرح الشاعر من خلال شعرية الوصف، صورة الكمامة والقفازين والخوف من الرشح والعطس وانتشار الوسواس البشري، خوفا من الموت، فيعتمد الشاعر على استخدام دوال شعرية تومئ إلى الخوف من فيروس كورونا (كمامة- الأنف- الفم- قفازات- حاسة اللمس- سعال- امرأة- عجوز- الفقد- وداع) . فمن الملحوظ أيضا أن الشاعر حسونة فتحي يرصد شعور الحزن في حالة الفقد دون وداع، حيث تم منع التجمعات والجنائز، حيث كانت وزارة الصحة تدفن الموتى في جوف الليل دون وداع المفقودين أو تشييعهم أو إقامة جنازة لهم. وفي ظني أن الذات الشاعرة تطرح حزنا عميقا داخل النفس حيث انقلبت الحياة، فتغيرت أحوال البلاد والعباد وانتشر الخوف والفزع في كل مكان، وصار الحزن حالة جمعية تهيمن على حياة البشر الذين لا يستطيعون توديع أحبتهم الوداع الأخير إلى القبور.
ما أقسى تلك اللحظات التي تسجلها قصيدة حسونة فتحي، مستخدما لغة شعرية حزينة تتحدث بحزن وألم، مقاومة كل أشكال الموت والغياب.